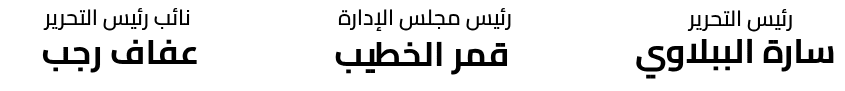الكاتب: محمد مخلوف
مقدمة:
شهد الحقل التربوي المغربي في العقود الأخيرة مجموعة من الإصلاحات والتحولات على كافة الأصعدة والمستويات، فقد استغنى خلال نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة عن المقاربة بالأهداف، فمع صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999 والذي نص صراحة على ضرورة تبني المقاربة بالكفايات والمقصود بالكفاية القدرة على تعبئة مجموعة من المعارف والمهارات والمواقف بشكل مدمج وفعال لمواجهة وضعيات معقدة ومشكلات حقيقية في سياقات مختلفة، كإطار مرجعي لتطوير المناهج والبرامج التعليمية، بهدف تبني رؤيا جديدة للتدريس تجعل المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية وهدفها الأساس، بإعطاء معنى للتعلمات وربطها بالسياق السوسيوثقافي للمتعلم وترتكز هذه المقاربة على مجموعة من النظريات والبيداغوجيات الحديثة في التعليم (النظرية البنائية/ بيداغوجية حل المشكلات…). وفي إطار شراكة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في إعداد الحقيبة التربوية الخاصة بمقاربة التثقيف بالنظير والمهارات الحياتية صدر دليل المهارات الحياتية والتثقيف بالنظير، ويندرج إعداد هذا الدليل في إطار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 /2030 في المغرب والتي تولي أهمية خاصة للتربية على القيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة وفضائل السلوك المدني، وقبل ثلاث سنوات أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خريطة الطريق 2022/2026 وهي خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى إرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.
لكن وبالرغم من كافة هذه البرامج والإستراتيجيات الإصلاحية إلا أن المدرسة المغربية لا زالت تنتج نسب كبيرة من المتعلمين غير متمكنين من مجموعة من التعلمات الأساس بشكل عام ومن المهارات الحياتية بشكل خاص، والتي من شأنها تسهيل اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، ومع تبني نظامنا التربوي لنموذج “المدارس الرائدة “وبداية تجريبه في مجموعة من المؤسسات العمومية، أصبح لزاما على المتعلم الانخراط في المجالات الست للحياة المدرسية وأدمجت ضمن جدول الحصص الأسبوعية.
إشكالية الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة المقترحة في تعديل وتوظيف البرامج الدراسية لتطوير مهارات الحياة لدى المتعلمين.
فكيف نجعل من برامجنا الدراسية ومن حصصنا الأسبوعية ألية من أليات تطوير مهارات الحياة لدى المتعلمين؟
ما أثر أنشطة الحياة المدرسية على نفسية وشخصية المتعلم؟
ولماذا المتعلم المغربي يحس بأن ما يتعلمه ضمن الأعمال التطوعية وداخل المنصات الرقمية يساعده على تغيير ذاته وحياته أكثر مما يتعلمه داخل حجرة الدرس؟
الأهمية العلمية والتربوية للموضوع:
لقد أكدت العديد من المنظمات والهيئات في تقاريرها على أهمية تنمية المهارات الحياتية لدى المتعلمين والتي تسمها بمهارات القرن الحادي والعشرين، ففي عام 1996 قدمت اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي والعشرين تقريرًا إلى اليونسكو، حمل عنوان: «التعلم ذلك الكنز المكنون» (ديولور، 1996) ، تم التطرق فيه بضرورة بناء فرد متعلم متعدد المهارات وقادر على المشاركة في أنظمة المجتمع. في ذات السياق، جاء التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمهارات الحياتية والعمل على تنميتها في تقرير للمنظمة العربية للثقافة والعلوم (السكو) 2002)) ، وهو ما أشار إليه كذلك تقرير منظمة الصحة العالمية who بتاريخ 2008، حيث ركزت على ضرورة تعليم مهارات الحياة لتنمية الجوانب النفسية والاجتماعية وتنمية قدرات الفرد والتكيف الإيجابي الذي يجعل التعامل مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها بشكل فعال.
تفاعلا مع هذه التقارير والتوصيات، لجأت العديد من الدول على المستوى الدولي والعربي إلى تبني هذه المقاربة داخل الأنظمة التعليمية لإعداد أفضل، لأجيال الغد. ففي الولايات المتحدة الامريكية مثالا، تبنت ولاية يوتا (UTAH) مشروعا للمهارات الحياتية أبرزت من خلاله أهمية بعض هذه المهارات مثل المهارات الشخصية ومهارات الاتصال والتفكير UTAH STATE OFFIC OF (eduction, 2006) وفي ذات السياق توصل مشروع وزارة التربية بولاية نيوجيرسي (New jersey) إلى حاجة المتعلمين لمستويات مختلفة من المعرفة والمهارات للحصول على الوظائف للإعداد لنواحي الحياة المختلفة المرتبطة بالتعليم والتطوير والنمو. (New jersey Departement Of Eduction9) . في كندا كذلك تلقى المتعلمون مجموعة من الدروس في إطار برنامج لتنمية المهارات الحياتية تم التركيز فيه على تنمية مهارة الإبداع، ووصف وقبول مشاعر الأخرين، وتقديم التغذية الراجعة، ونظام حل المشكلات، كما ركز على المهارات المعرفية والوجدانية والنفس حركية (الجديبي، 2010) على الجانب العربي، تبنت مجموعة من الدول مثل مصر والجزائر والأردن وسلطنة عمان رفع مستوى المهارات لدى المتعلمين من خلال تبني مشروع تعلم للريادة، والذي تم وضعه من قبل منظمة اليونسكو وشركة سترات ريال البريطانية ( Start Real) والذي اهتم بتعزيز الثقة، والاعتزاز بالنفس، وتنمية المهارات والقيم (المصري وأخرون 2010) . من جهته، انخرط المغرب في مجموعة من المبادرات التي تروم تنمية المهارات الحياتية كمبادرة فرصتي التي أشرفتا عليها المنظمة الدولية للشباب والمنظمة الدولية للهجرة (OIM) سنة 2015 ومبادرة مهارتي التي أطلقتها منظمة اليونيسف سنة 2017.
إن هذا الإدراك العميق لأهمية امتلاك المهارات الحياتية يدفعنا لإعادة النظر في فلسفة التعليم داخل الفصول الدراسية وكذلك ضمن أنشطة الحياة المدرسية، فمن المؤكد أن تنمية المهارات الحياتية للمتعلم سيكون له الأثر الكبير في زيادة الدافعية وحافز التعلم لديه (محمود 2004 وصايمة، 2010) ، كما أن الانتقال من مستوى إلى مستوى أفضل في المهارات على طول مساره الدراسي سيوصل المتعلم إلى درجة التمكن، مما سيساعده على الارتقاء في مستواه المهني والنفسي والاجتماعي (أسكاوس وأخرون 2005) . كما أن إصلاح المنظومة التعليمية للمجتمعات العربية من خلال التركيز على تنمية المهارات الحياتية سيمكن من تجاوز فجوة التخلف الحضاري (مازن، 2002) .
المحور الأول:
الإطار المفاهيمي للموضوع.
مفهوم المهارات الحياتية:
المهارات الحياتية هي مهارات غير تقنية، تتعلق بالقدرات الشخصية والاجتماعية والذهنية والاتصالية للفرد. وتشمل هذه المهارات القدرة على التواصل بفعالية، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، والقيادة، وحل المشكلات، وإدارة الصراع مع الأخرين، والتفكير النقدي، والتحليل، وقدرة التحمل، والتعامل مع النجاح والفشل بشكل صحيح، والقدرة على التعلم والتكيف مع التغيرات والتحولات.
هذه المهارات تعد جوهرية لنجاح الفرد في بيئة العمل والحياة اليومية، فهي تمكنه من التفاعل بفعالية مع الأخرين وإنشاء علاقات إيجابية في محيط عمله، وتساعده على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتزيد من فرص نجاحه المهني والشخصي. لأجل هذه الأسباب نجد أن مصطلح المهارات الناعمة صار يتكرر كثيرا في الفترة الأخيرة، واستحال مطلبا أساسيا للأنظمة التعليمية في العصر الحالي، بهدف تشكيل وصقل شخصية المتعلمين، وإعدادهم كأجيال للمستقبل قادرين على مواجهة قضايا العصر، ومشكلاته، وتحدياته، بتضمين تطبيقاتها في السياقات التعليمية.
بناء عليه، حددت منظمة اليونيسف سنة 2017، بالاعتماد على مجموعة من الأدبيات والمشاورات الواسعة، حزمة من اثني عشر مهارة أساسية باستخدام نموذج الأبعاد الأربعة للتعلم: البعد المعرفي (المتعلم) والبعد الفعال (الأهلية للعمل) والبعد الفردي (القدرة الشخصية) والبعد الاجتماعي (المواطنة الفعالة)، حيث ثم الاستناد في ذلك على القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
تعكس المهارات الحياتية الاثنا عشر التفاعل الحيوي بين كل من الأبعاد الأربعة للتعلم وتسهم في تطورها، ويمكن لمهارة حياتية واحدة أن تساهم في أن يصبح المتعلم أكثر ابتكارا، وفي الوقت نفسه أن يكون عاملا أكثر إنتاجية، وأن يشعر بالقوة الشخصية وأن يصير مواطنا أكثر مشاركة، وبالتالي تعزيز المهارات الناعمة الأخرى، لذلك لا يمكن الحديث عن حدود واضحة بين مختلف هذه المهارات إذ هناك تداخل فيما بينها.
من جهة أخرى، إن أهم ما يجب التأكيد عليه هو كون هاته المهارات الحياتية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجانب القيمي. ذلك لأنها تعكس رؤية شاملة وتحويلية للتعليم النوعي القائم على أساس أخلاقي صلب يعتبر على أن التعليم هو دعم لكرامة الإنسان وتعزيز للقيم القائمة على حقوق الإنسان، وليس فقط تعزيز أداء الفرد في العمل وتحقيق أقصى قدر من النمو والإنتاجية. إن الجانب القيمي الذي تركز عليه هذه المهارات الحياتية يندرج ضمن نهج (إعادة التفكير في التعليم) بحيث تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ مفهوم المواطنة والقيم الإنسانية.
المحور الثاني:
المدرسة المغربية وبناء الكفايات الحياتية.
نستهل هذا المحور بقولة للملك محمد السادس في خطاب العرش سنة 2010، يقول فيها “من مسؤولية الجميع، الإقدام على اتخاذ قرارات شجاعة، لتحقيق الملاءمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني، وبين مستلزمات الاقتصاد العصري، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال.”
وفي تقرير النموذج التنموي الجديد الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نجد الخيار الأول من الباب الخامس ينص على خلق منظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المتعلم، وقائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطن فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وفي الإجراء رقم 5 من الباب نفسه يؤكد على الرفع من جودة التكوين الأساسي والمستمر: يجب أن يمكن التكوين الأساسي من امتلاك نصية الكفايات التقنية والبيداغوجية والمهارات الحياتية. أما التكوين المستمر، فيجب أن يمكن من تطوير وتحيين الكفايات التي سبق اكتسابها .
من خلال ما سبق سنجد أن الخطب الملكية والسياسات العمومية وحتى الاستراتيجيات الإصلاحية الخاصة بمنظومة التربية والتكوين تؤكد وتشدد على مبدأ أساس وهو تكوين متعلم متمكن من مجموعة من الكفايات الأساس ومهارات حياتية، تيسر له الاندماج الاجتماعي والاقتصادي في مجتمع المعرفة والتقدم.
لكن المتتبع للشأن التربوي المغربي أو الممارس داخل الأوساط التعليمية، سيلاحظ غياب شبه تام لهذه المهارات داخل الفصول الدراسية وإن كانت حاضرة بشكل نسبي داخل أنشطة الحياة المدرسية التي بدورها يعرف تفعيلها عدة إكراهات وتحديات.
فبالرغم من صعوبة العثور على إحصاءات وطنية شاملة وحديثة ترصد مستوى المهارات الحياتية بمعناها الواسع في المغرب، نظرا لكونها مهارات غير أكاديمية يصعب قياسها بشكل موحد، ومع ذلك، تشير التقارير والأبحاث المتوفرة إلى وجود تحديات في المهارات التي يحتاجها سوق العمل، والتي تتضمن العديد من المهارات الحياتية والمهنية.
فيما يلي ملخص لأبرز النقاط الإحصائية والملاحظات الرئيسية المتعلقة بمستوى المهارات في المغرب:
1. تحدي المهارات وسوق العمل.
تشير التقارير الدولية والوطنية إلى وجود فجوة بين المهارات التي يكتسبها الشباب من خلال التعليم وتلك التي يتطلبها سوق العمل المغربي:
• تفاوت في المهارات (Skill Mismatch): وجدت دراسة (باستخدام نهج التقييم الذاتي لـ World Bank’s STEP) أن نسبة 55.1% من الموظفين في العينة لديهم تفاوت في المهارات، مما يشير إلى أن مؤهلاتهم التعليمية لا تتطابق تمامًا مع متطلبات وظائفهم.
• بطالة الشباب المتعلم: وفقًا لآخر بيانات المندوبية السامية للتخطيط الصادرة في الربع الثاني من عام 2025، بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 35.8% في المغرب، بينما كان معدل البطالة الإجمالي 12.8%. يسلط هذا الرقم الضوء على التحدي الكبير الذي يواجهه الشباب في سوق العمل المغربي مقارنة بالمتوسط العام.
• عقبات التوظيف: يرى الشباب أن عدم التطابق بين المؤهلات التعليمية ومتطلبات الوظيفة (34%) ونقص الخبرة (18%) هي العوائق الرئيسية أمام التوظيف. ويشير البعض أيضًا إلى نقص المهارات الريادية أو الدافعية لدى الشباب (15%).
2. التصنيف في مؤشرات المهارات العالمية.
تعكس التصنيفات الدولية التحديات التي يواجهها المغرب في إعداد القوى العاملة للمستقبل:
• مؤشر المهارات المستقبلية العالمي (QS Global Future Skills Index): صُنّف المغرب في المرتبة 78 من أصل 81 دولة في أحدث تقرير (اعتبارًا من أوائل عام 2025)، مما يدل على ضعف في مواءمة مهارات القوى العاملة مع متطلبات التعلم مدى الحياة والوظائف المتطورة (مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء).
3. جهود دمج المهارات الحياتية:
بعض الجهود لتعزيز المهارات الحياتية في المنظومة التعليمية، بالرغم من نقص الإحصاءات المباشرة لنتائجها:
• مبادرة اليونيسف: يشهد المغرب تقدمًا في تطبيق “مبادرة تعليم المهارات الحياتية والمواطنة” (LSCE) التي أطلقتها اليونيسف واليونيسكو. تركز هذه المبادرة على تعزيز مهارات الشباب في المدارس وتوفير الدعم لتنميتهم الشخصية والمهنية، بما في ذلك مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل الفعال، والتعامل مع الضغط العاطفي، والمرونة.
• التعليم العالي: أُدرجت المهارات الحياتية كجزء من إصلاحات التعليم العالي (مثل إصلاح 2019 BD)، لتشمل مهارات التعلم، والمهارات الحياتية، ومهارات المسؤولية المجتمعية، والمهارات المهنية بهدف تحسين جاهزية الخريجين لسوق العمل.
المحور الثالث:
عوائق تنمية المهارات الحياتية داخل المدرسة المغربية:
على الرغم من الأهداف النبيلة للمقاربة بالكفايات واعتبارها خياراً استراتيجياً للإصلاح، فإن تطبيقها الفعلي في المدرسة المغربية يواجه العديد من التحديات التي أدت في كثير من الأحيان إلى تبنيها نظريا والاشتغال بالأهداف والمضامين إجرائيا وعمليا.
ويمكن تصنيف العوائق التي تعرقل التدريس بالكفايات داخل مدارسنا المغربية إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1. العوائق المنهجية والبنيوية:
• اكتظاظ المنهاج الدراسي: المناهج الحالية مثقلة بالمعارف الأكاديمية التقليدية، مما لا يترك حيزًا زمنيًا أو مكانيًا كافيًا لإدراج أنشطة المهارات الحياتية التي تتطلب وقتًا للتطبيق والممارسة والنقاش.
• مركزية المحتوى المعرفي: الأنظمة التعليمية تركز بشكل كبير على الاختبارات الموحدة القائمة على استرجاع المعلومات (الحفظ)، في حين أن المهارات الحياتية تتطلب تقييمًا قائمًا على الأداء، وهذا يخلق ضغطًا على المدرسين لإهمال المهارات لصالح “تغطية البرنامج”.
• غموض التعريف وتشتت الإدماج: عدم وجود إطار وطني موحد وواضح لكيفية تجزئة وقياس هذه المهارات، مما يؤدي إلى إدماج سطحي أو عشوائي (كإضافة نشاط غير متصل بصلب المادة).
2. العوائق المتعلقة بتكوين المدرسين:
• نقص التأهيل والتكوين: عدم تمكين المدرسين من تكوين ذو جودة يزود المدرسين باستراتيجيات التدريس اللازمة لتنمية المهارات الحياتية (مثل التعلم القائم على المشاريع، المحاكاة، لعب الأدوار).
• التحول في دور المدرس: يتطلب تدريس المهارات الحياتية تحولاً من كون المدرس ملقنًا للمعرفة إلى ميسّر وموجّه، وهذا التغيير يتطلب دعمًا نفسيًا وإداريًا لا يتوفر دائمًا.
القابلية للتغيير: قد يقاوم بعض الفاعلين التربويين التغيير بسبب الخوف من المجهول أو العبء الإضافي أو الافتقار إلى الثقة في قدرتهم على تقييم مهارات “غير مادية” مثل الذكاء العاطفي.
3. العوائق الإدارية والثقافية والبيئية:
• الافتقار إلى الدعم الإداري: قد لا توفر الإدارة المدرسية الموارد الكافية (كالتجهيزات، تخصيص قاعات، تخفيض نصاب الحصص…) أو البيئة المدرسية الداعمة (ثقافة تشجع على التجربة والخطأ).
• ثقافة الأسرة والمجتمع: ميل بعض الأسر إلى تفضيل العلامات والنجاح الأكاديمي التقليدي على تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، مما يقلل من قيمة المهارات الحياتية في نظر المتعلم نفسه.
• مشكلة القياس والتقويم: الصعوبة في تطوير أدوات وشبكات تقويمية صادقة وموثوقة لقياس مدى اكتساب المتعلم لمهارة مثل “التواصل الفعال” أو “التفكير النقدي” مقارنة بالاختبارات التقليدية.
بالإضافة إلى هذه العوائق هناك مجموعة من الصعوبات على مستوى تفعيل أنشطة الحياة المدرسية، إذ لا يحظى التنشيط المدرسي في المؤسسات التعليمية بالاهتمام الذي يستحقه، فالتوجيهات الإدارية الرسمية لا تشير إليه إلا في مناسبات الاحتفال بالأعياد والأيام الوطنية والدولية، وتبقى هذه التوجيهات إلزامية نظريا دون أن تفعل إداريا وميدانيا بالشكل المطلوب، بسبب ضعف المبادرة لدى الفاعلين التربويين، من أساتذة وتلاميذ وإداريين وغيرهم، وانعدام المنشطين المتخصصين في المجال .
المحور الرابع:
مقترحات وحلول لتطوير مهارات الحياة لدى المتعلمين:
تعدّ المدرسة البيئة الأساسية التي لا تقتصر مهمتها على تزويد المتعلمين بالمعرفة المدرسية فحسب، بل تمتد لتشمل إعدادهم ليصبحوا أفرادًا فاعلين وقادرين على التعامل بمرونة مع تحديات الحياة اليومية. إن مهارات الحياة (Life Skills) هي مجموعة من القدرات الشخصية والاجتماعية والمعرفية التي تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة، وحل المشكلات بفعالية، والتواصل الإيجابي، والتحكم في الذات. وعليه، فإن دمج هذه المهارات في صلب العملية التعليمية يُعدّ ضرورة تربوية ومجتمعية ملحة.
لتحقيق الاندماج الفعال لمهارات الحياة في المناهج والأنشطة المدرسية، يمكن تبني مجموعة من الحلول والمقترحات العملية:
1. دمج المهارات ضمن البرنامج الدراسي.
بدلاً من إضافة مواد منفصلة قد تثقل كاهل المتعلمين، يمكن دمج مهارات الحياة بشكل عرضي ضمن المواد الدراسية الحالية:
• مادة اللغة العربية واللغات الأجنبية: التركيز على مهارات التواصل الفعال، الاستماع النشط، والتقديم والعرض عبر المناقشات والأنشطة الإلقائية.
• مواد العلوم والرياضيات: تنمية مهارات التفكير النقدي، حل المشكلات، واتخاذ القرار من خلال المشاريع القائمة على الاستقصاء والتحليل.
• المواد الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا): تعزيز مهارات المواطنة المسؤولة، التعاطف، وفهم التنوع الثقافي عبر دراسة القضايا المجتمعية والتاريخية.
2. اعتماد التعليم القائم على المشاريع (PBL).
يعتبر التعلم القائم على المشاريع نهجًا فعالًا يضع المتعلم في سياق مشكلة أو تحدٍ حقيقي يتطلب منه العمل التعاوني والبحث والاستنتاج. هذا الأسلوب ينمّي عدة مهارات بشكل متزامن، أبرزها:
• العمل الجماعي والقيادة: من خلال توزيع الأدوار داخل الفريق.
• إدارة الوقت وتنظيم المهام: لتسليم المشروع في الموعد المحدد.
• المرونة والتكيف: عند مواجهة عقبات في سير العمل.
3. إنشاء نوادٍ وأنشطة لاصفية متخصصة.
توفير مساحات اختيارية للمتعلمين لممارسة مهاراتهم بعيدًا عن ضغط الامتحانات، مثل:
• أندية المناظرات: لتطوير مهارات الإقناع والاستدلال المنطقي.
• أندية المبادرات المجتمعية (التطوع): لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والتعاطف.
• برامج التوجيه والإرشاد (Mentoring): حيث يقوم المتعلمون الأكبر سناً بتوجيه الأصغر، ما ينمي لديهم القيادة والمسؤولية.
4. تدريب المدرسين على مهارات الحياة.
المدرس هو حجر الزاوية في هذه العملية؛ لذا، يجب تزويده بالأدوات اللازمة مثل:
• عقد ورش عمل ودورات متخصصة تركز على كيفية تضمين مهارات الحياة في خطط الدروس.
• تمكين المدرسين من استخدام أساليب التعلم النشط التي تشجع على التفاعل بدلاً من التلقين.
• تدريبهم على الإدارة الإيجابية للفصل وتقنيات حل النزاعات بين المتمدرسين.
5. إشراك الأسرة في عملية البناء.
لا يمكن للمدرسة أن تعمل بمعزل عن الأسرة، فمهارات الحياة تُكتسب وتُعزز في كلا البيئتين:
• تنظيم ورشات لأولياء الأمور حول أهمية الذكاء العاطفي وكيفية تعزيزه في المنزل.
• التواصل المستمر حول المهارات التي يتم التركيز عليها في المدرسة وكيف يمكن تطبيقها في الحياة اليومية للمتعلم.
خاتمة:
حاصل القول التعلم هو جوازك نحو المستقبل، والغد يتهيأ لأولئك الذين يتعلمون دائما على حد تعبير مالكوم إكس، فنحن في حاجة إلى غرس مبدأ التعلم مدى الحياة لدى أطفالنا، ولتحقيق هذه الغاية لابد من تعليم مبني على تعزيز القدرات وبناء الكفاءات وهذا ما يستوجب ضرورة التركيز على صناعة متعلم متمكن من العديد من مهارات الحياة دون إغفال للتعلمات الأساس، وكل هذا يتطلب إرادة سياسية وحكامة تدبيرية قوية.
ديلور جاك 1999، التعلم: ذلك الكنز المكنون ، باريس: اللجنة الدولية للتعليم في القرن الحادي والعشرين.( اليونسكو)
المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم (2002)، تونس.
World Health Organisation 2008 . Skills for Health; who.
Utah state office of eduction 2006.
New Jersey Department of Education, (2004): Career education and consumer family and life
skills, http //www.nj.gov/hide/aps/cccs.
لجديبي رأفت محمد علي (2010). تنمية المهارات الحياتية لدى طلاب المرحلة الثانوية في ضوء التحديت والاتجاهات المعاصرة، رسالة دكتورا كلية التربية، جامعة أم القرى. المملكة العربية السعودية.
المصري منذر وآخرون (2010). دراسة حالة عن الدول العربية (الأردن) التعليم للرʮدة في الدول العالمية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة.
3 محمود عبد الرازق مختار (2004). فعالية وحدة مقترحة في أناشيد وأغاني الأطفال، لإثراء بعض المهارات الحياتية اللازمة لهم، مجلة نور المعرفة، عدد 24أبريل.
أسكاوس فيليب وآخرون (2005). تنمية المهارات الحياتية لدى طلاب التعليم الثانوي في إطار مناهج المستقبل، القاهرة: المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.
مازن محمد حسام (2002). نموذج مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتية في منظومة المنهج التعليمي في إطار مفاهيم الأداء والجودة الشاملة، المؤتمر الرابع عشر، مناهج التعليم في ضوء الأداء، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، جامعة عين شمس، القاهرة، المجلد الأول.
نهج المقاربة المهارتية، أسماء العيساوي مجلة المعرفة، العدد الثاني عشر. يناير 2024 ، ص. 311.
تقرير النموذج التنموي الجديد للمغرب ص 67.
مقال بعنوان معيقات الحياة المدرسية وحلولها.
![]()